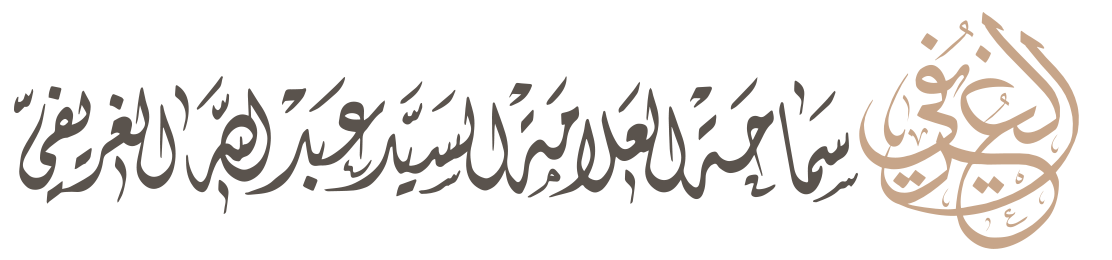حديث الجمعة 658: محطَّات التَّعبئة الرُّوحيَّة – كم هي الحاجة ضروريَّة أنْ تُقاربَ هُمومَ الوطنِ بين وقت وآخر
مسجد الإمام الصَّادق (عليه السَّلام) – القفول حديث الجمعة (658) التَّاريخ: يوم الخميس (ليلة الجمعة) 17 ذو القعدة 1446هـ | الموافق: 15 مايو 2025 م
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وأفضلُ الصَّلواتِ على سيِّدِ الأنبياءِ والمرسلين مُحمَّدٍ وآلِهِ الهُداةِ الميامين.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
محطَّات التَّعبئة الرُّوحيَّة
إذا كانَ للتَّعبئةِ الماديَّةِ مَحَطَّاتُها، فإنَّ للتَّعبئةِ الرُّوحيَّةِ مَحَطَّاتها، مِن خلالها نراجعُ كلَّ واقعِنا الرُّوحيِّ، مِن خِلالِها نمتلئ، ننشط، نصوغ أنفسَنا، ننصنع وجودًا جديدًا.
شهرُ اللهِ محطَّةٌ كبرى، وكذلك شهرُ الحجّ، وشهر المحرَّم، ومناسبات دينيَّة كبيرة… تتآزر هذه المواقع؛ لتصنع فينا الوْعيَ، والطُّهرَ، والقِيمَ، والخُلقَ والصَّلاحَ، والتَّقوى، والنَّشاط…
وإذا كانت المحطَّاتُ مؤقَّتةً، فهل تبقى منتجاتُها، وهل تستمر؟
قد تبقى…
ورُبَّما يبقى منها القليل إلى أمدٍ قصير.
ورُبَّما تنتهي عاجِلًا.
والسُّؤالُ الكبيرُ الذي يُطرح هنا:
كيف نُؤسِّسُ لبقاء المعطياتِ التي امتلأنا بها في أشهرِ العطاءِ الرُّوحيِّ والإيمانيِّ والأخلاقيِّ والثَّقافيِّ؟
قد يُقال:
إنَّ للمواسمِ الدِّينيَّة الكُبرى خُصوصيَّاتُها، وهذه الخصوصيَّاتُ لا تتكرَّر في الأشهر الأخرى،
فشهر اللهِ له خُصوصياتُه الكبرى
وللحجّ معطياته المتميِّزة
وللمحرَّمِ وهجُه
وللمولد النَّبويِّ عبقُه
وللغدير إشعاعاتُه
وللنِّصف مِن شعبان فيوضاتُه
وهكذا بقيَّة المناسباتِ التي تشكِّل استثناءً وحضورًا لا يتكرَّر.
هذا الكلام صحيح تمامًا، فالعناوين الكبرى لها تمركزها في العقل والوجدان.
فغيرها مِن الأزمنة لا يملك هذا التَّمركز
فالفيوضات الرَّمضانيَّة
وإشراقات الحجّ إلى بيت الله
والوجدان العاشورائيّ
وهكذا خصوصيَّات المناسبات الكبرى
لها زمانُها وتمركزها.
إلَّا أنَّ هذا التَّمركزُ إذا كان صادقًا كلَّ الصِّدقِ، وواعيًا كلَّ الوعي، فإنَّه لا ينحجز في الزَّمانِ والمكانِ بل يمتدُّ ويتَّسع ويتحرَّك.
فشهر اللهِ بما له مِن خُصوصِيَّاتِ متميِّزة يُعبِّئ الصَّائمين بشُحُناتٍ روحيَّةٍ، وبقدر ما تكون التَّعبئةُ متأصِّلةً ومتجذِّرةً تملك بقاءً في الدَّاخلِ، وهذا البقاءُ لا يعرف الانحجاز في الزَّمانِ وفي المكانِ، ولا يعرف السُّكونَ، بل يتَّسع وتكون امتداداته مستمرِّةً.
هذا هو دور الصَّومِ الفاعل.
وهكذا دورُ الصَّلاةِ الفاعلة.
وهكذا دور الدُّعاءِ الفاعل.
ودور الذِّكر الفاعل، ودور التِّلاوة الفاعلة.
وهكذا دور الحَجّ، ودور العُمرة، ودور الزِّيارة.
ودورُ كلِّ المناسبات الدِّينيَّة.
فقِيمة العِبادةِ بقدر ما يمتد دورها زمانًا ومكانًا.
فإذا كانت الصَّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا تكون القِيمة بقدر ما يتَّسع هذا الدَّور زمانًا ومكانًا.
مِن المصلِّين مَن لا أثر لصلاتِهم، فلا تأمرهم بمعروفٍ ولا تنهاهم عن منكرٍ!
- جاء في الكلمة عن رسولِ الله (صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم):
«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ الصَّلَاةَ، وَطَاعَةُ الصَّلَاةِ أنْ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ».([1])
- وفي كلمة أخرى له (صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم):
«مَن لَم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ لَم يَزدَد مِنَ اللهِ إلَّا بُعدًا».([2])
- وفي الكلمة عن الإمامِ الصَّادق (عليه السَّلام): «اِعلَمْ أنَّ الصَّلاةَ حُجزَةُ اللهِ في الأرضِ، فَمَن أحَبَّ أنْ يَعلَمَ ما أدرَكَ مِن نَفعِ صَلاتِهِ، فَلْيَنظُرْ: فإنْ كانَت صَلاتُهُ حَجَزَتهُ عنِ الفَواحِشِ والمُنكَرِ فإنَّما أدرَكَ مِن نَفعِها بقَدرِ ما احتَجَزَ، …».([3])
إنَّ وظيفة الصَّلاة الحقَّة أنَّها تنهى عن الفحشاء والمنكر:
- قالَ اللهُ تعالى في سورة العنكبوت (الآية 45):
﴿… وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِۗ وَلَذِكۡرُ ٱللَّهِ أَكۡبَرُۗ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ مَا تَصۡنَعُونَ﴾.
فما دام العبد يُصلِّي صلاةً صادقةً خاشعةً، فهذهِ الصَّلاة تعبِّئه بطاقةٍ روحيَّةٍ تحصُّنُه في مواجهة كلِّ الفواحش والمُنكرات.
وحينما تتجمَّد الصَّلاةُ عن هذه التَّعبئة الرُّوحيَّة فهنا خللٌ في التَّعاطي مع الصَّلاة.
ابحث عن هذا الخلل:
رُبَّما يكون الخللُ فقهيًّا.
رُبَّما يكون الخللُ فِكريًّا.
رُبَّما يكون الخللُ رُوحيًّا.
رُبَّما يكون الخلل سُلوكيًّا.
إنَّ للصَّلاةِ ضوابطَها الفقهيَّة.
وإنَّ للصَّلاةِ ضوابطَها الرُّوحيَّة، وضوابطَها الفكريَّة، وضوابطَها العمليَّة.
فغيابُ الضَّوابطِ الفقهيَّة ينتج بطلانًا للصَّلاة: (وضوءٌ باطل، غسلٌ باطل، ركوعٌ باطل، سجودٌ باطل …).
وغيابُ الضَّوابطِ الرُّوحيَّة يُنتجُ جفافًا للصَّلاة.
- ﴿… وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ …﴾.([4])
وغيابُ الضَّوابطِ الفكريَّة يُنتجُ غيابًا للوعي.
للصَّلاة مضامين كبرى، وكلَّما ارتقى الوعي بهذه المضامين ارتقت القِيمةُ للصَّلاة.
- في الكلمة عن الإمامِ زين العابدين (عليه السَّلام): «وحَقُّ الصَّلاةِ:
– أنْ تَعلَمَ أنَّها وِفادَةٌ إلى اللهِ عَزَّ وجلَّ
– وأنَّتَ فيها قائمٌ بينَ يَدَيِ اللهِ عَزَّ وجلَّ
– فإذا عَلِمتَ ذلكَ
– قُمتَ مَقامَ الذَّليلِ الحَقيرِ، الرَّاغِبِ الرَّاهِبِ، الرَّاجِي الخائفِ، المُستَكِينِ المُتَضَرِّعِ، المُعُظِّمِ لِمَن كانَ بَينَ يَدَيهِ بالسُّكونِ والوَقارِ
– وتُقبِلُ علَيها بِقَلبِكَ
– وتُقِيمُها بِحُدُودِها وحُقُوقِها».([5])
فمتى ما توفَّرت الصَّلاة على ضوابِطها الفقهيَّة، وضوابِطها الرُّوحيَّة، وضوابِطها الفكريَّة، وضوابِطها العمليَّة؛ كانت الصَّلاة كفارة للذُّنوب التي بينه وبين الله عزَّ وجلَّ.
- قالَ رسولُ الله (صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم):
«إذا قامَ العَبدُ إلى الصَّلاة، فكانَ هَواهُ وقَلبُهُ إلَى اللهِ تعالى، انصَرَفَ كَيومِ وَلَدَتهُ أُمُّهُ».([6])
- كان النَّبيُّ (صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم) هو وأصحابه في ظلِّ شجرة، فأخذ غصنًا مِن تلك الشَّجرة فنفضه فتساقط ورقُهُ، وأخبرهم عمَّا صنع، قالَ (صلَّى الله عليه وآلِهِ وسلَّم):
«إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ تَحَاتَّتْ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّتْ وَرَقُ هذهِ الشَّجَرَةِ».([7])
كلمة أخيرة
كم هي الحاجة ضروريَّة أنْ تُقاربَ هُمومَ الوطنِ بين وقت وآخر، ليس لتكدير المزاجات وإرباكِ المشاعر، وإنَّما لتنقية المناخاتِ، ولا يخلو وطنٌ مِن مُكدِّراتٍ، ولا يخلو وطن مِن بعضِ أزماتٍ، فأنْ نغلق الأبصار عن هذه المُكدِّراتِ، وأنْ تغلقَ الآذان عن هذه الأزماتِ أمرٌ ليس في صالحِ الأوطانِ.
مسؤوليَّة الأنظمة أنْ تنفتح على أزماتِ الأوطان.
ومسؤوليَّة الشُّعوب أنْ تحملَ همومَ الأوطان.
فإذا تآزرتْ مسؤوليَّاتُ الأنظمةِ، وإراداتُ الشُعوب نشطت الخياراتُ الصَّالحةُ، وتحرَّكتْ المساراتُ النَّاجحة.
وإذا كان العكس، فتجمَّدت مسؤوليَّاتُ الأنظمة، وتكلَّستْ إراداتُ الشُّعوب كانت الضَّحيَّة هي الأوطان، وكانت الفاشلة هي الأنظمة، وكانت الضَّائعة هي الشُّعوب.
إذًا حينما يقاربُ خطابُنا الدِّينيُّ بعضَ همومِ هذا الوطن، فهو تعبيرٌ عن ولاءٍ صادقٍ، وإخلاصٍ واثق، والعكس صحيح؛ فحينما يصمتُ الخطابُ، وتسكتْ الكلمةُ يتكلَّس الولاء، ويتكدَّر الإخلاصُ.
حينما يتساءل الخطابُ عن بعضِ همومٍ، وعن بعضِ أزماتٍ فهو تساؤلٌ مشروعٌ، يحمل كلَّ الحبِّ، وكلَّ الولاء للوطن، وأمَّا إذا تعطَّل هذا التَّساؤل كان الضَّحيَّة هو الوطن.
حينما يكونُ هناك عاطلونَ مِن أبناءِ الوطنِ رغم الكفاءاتِ والقُدُراتِ.
وحينما يزحفُ على مواقعِ العمل وافدون.
يكون التَّساؤلُ مشروعًا ومطلوبًا.
لا عُقدةَ أنْ يستفيد الوطنُ مِن خِبراتٍ وافدةٍ ما دام هناك عجزٌ في كفاءاتِ الوطن.
وأمَّا إذا كان الأمر ليس كذلك.
هنا التَّساؤلُ مشروعٌ ومطلوبٌ.
وهذا التَّساؤل يُعبِّرُ عن غيرةٍ صادقةٍ على هُويَّة هذا الوطنِ، وعن حُبِّ واثقٍ لهذه الأرض.
ولا يحمل الحبَّ كلَّ الحبِّ للوطنِ، للأرضِ إلَّا مَنْ تَجذَّر في هذه التُّربة، وتأصَّل في تاريخها.
دعُونا نتآزرُ بصدقٍ نظامًا وشعبًا على حراسةِ هُويَّةِ هذه الأرضِ الطَّيِّبةِ، وحمايةِ هذا التَّاريخِ الأصيلِ، هذه الحراسةُ أمانةٌ كُبرى، وهذه الحمايةُ هَدَفٌ مُقَدَّسٌ.
ولا يمكن مِن أجلِ حَرَاسةِ الأَوطانِ أنْ تنفردَ الأنظمةُ ويغيبُ دورُ الشُّعوبِ، ولا أنْ تنفردَ الشُّعوبُ ويغيبُ دورُ الأنظمةِ.
وحينما تتناقض المسَارات، مساراتُ الأنظمة ومساراتُ الشُّعوب تكون الأوطانُ هي الضَّحيَّة.
وكيف يتأسَّسُ هذا التَّقاربُ؟
الأمر يحتاج إلى جُهودٍ مُكَثَّفةٍ، وبصيرةٍ، وصادقةٍ، ومتآزرةٍ.
ولا يكفي الأمنياتُ، ولا تكفي الخِطاباتُ والشِّعاراتُ.
- ما لم تتحرَّكْ الإراداتُ الخيِّرةُ.
- والنَّوايا الطَّيِّبة.
- والمساراتُ البصيرة.
- والقناعاتُ المتأصِّلة.
- والخياراتُ الصَّائبة.
هكذا تتأسَّس الانطلاقاتُ النَّاجحةُ لمعالجةِ كلِّ الأزماتِ، وكلِّ المُكدِّراتِ، بما تفرضه هذه المعالجةُ مِن تأصيلٍ جادٍّ لعناوينِ الإصلاحِ، هذه العناوين التي يجب أنْ تتحرَّكَ على الأرضِ بكلِّ صِدْقٍ، وبكلِّ إيمانٍ، وبكلِّ حُبٍّ.
شعارُ الإصلاح مطلوبٌ مِن الأنظمةِ، ومِن الشُّعوبِ بشرط أنْ لا يتحوَّل عنوانًا للاستهلاكِ، وعنوانًا للمزايدات، بل عُنوانَ بناءٍ، وعُنوانَ تغيير، وعُنوانَ خير، وعُنوانَ عَدْلٍ، وعُنوانَ كرامة.
فما أكثر الشَّعاراتِ المُفرَّغة، وما أكثر الشِّعاراتِ المُفلِسَة، وكم أرهقت هذه الشِّعاراتُ أنظمةً وشُعوبًا وأوطانًا، وكم أنتجت أزماتٍ وتوتُّراتٍ وإرباكات.
وأكرِّر، وأكرِّر، أنَّه لا تُعالج أزماتُ الأوطان إلَّا إذا تآزرت كلُّ القُدرات الرَّسميَّة والشَّعبيَّة، وتوحَّدتْ الهُموم، وخلصت النَّوايا، وتقاربت الإرادات، وتلاحمت المَسارات.
حينما تنطلق خطواتٌ جادَّةٌ في اتِّجاه البناءِ والإصلاح وإزالة المُكدِّرات مطلوبٌ أنْ تُبارك، هكذا تُحمى الأوطان، وتهنأ الشُّعوب، وتكبُر الأنظمة، وحينما تتعثَّر الخطوات مطلوبٌ أنْ تُرَّشد، أنْ تُصحَّح، لكيلا تتحوَّل أزماتٍ، ولكيلا تتحوَّل مُعوِّقاتٍ، هكذا يصدُقُ الولاءُ للأرض والوطن، وللدِّين والقِيم.
وآخرُ دَعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين.
[1] المجلسي: بحار الأنوار 18 ق 2/9، (ك: الطَّهارة والصَّلاة، ب 1: فضل الصَّلاة …).
[2] المجلسي: بحار الأنوار 18 ق 2/9، (ك: الطَّهارة والصَّلاة، ب 1: فضل الصَّلاة …).
[3] الصَّدوق: معاني الأخبار، ص 237، (ب: معنى ما روى أنَّ الصَّلاة حجزة الله في الأرض)، ح 1.
[4] سورة النِّسَاء: الآية 142.
[5] الصَّدوق: من لا يحضره الفقيه 2/384، (ك: الزّيارات، ب 395: الحقوق)، ح 3216.
[6] المجلسي: بحار الأنوار 18 ق 2/401، (ك: الطَّهارة والصَّلاة، ب 16: آداب الصَّلاة)، ح 59.
[7] المجلسي: بحار الأنوار 18 ق 2/9، (ك: الطَّهارة والصَّلاة، ب 1: فضل الصَّلاة …)، ح 17.